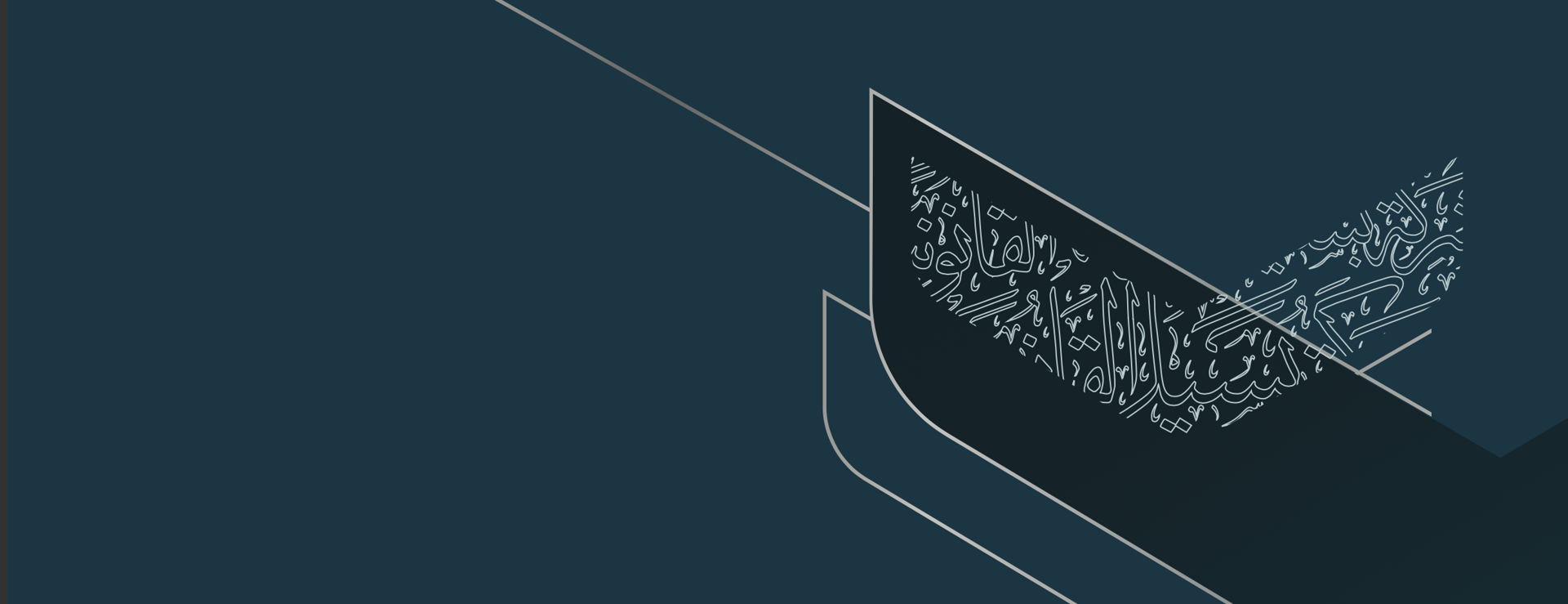الحق العام والوقاية من الأخطاء الطبية في القضاء السعودي
جود الصبحي


الحق العام والوقاية من الأخطاء الطبية في القضاء السعودي
المقدمة:
الخطأ الطبي لم يعد محصورًا في اختصاص الهيئة الصحية الشرعية، بل بدأت المحاكم العامة تنظر بعض القضايا ذات البعد العام خصوصًا تلك التي تمس النظام العام أو سلامة المجتمع، فالأخطاء الطبية لا تؤثر على مريض بعينه، بل تهز ثقة المجتمع في النظام الصحي وهذا ما يجعل تدخل القضاء العام مشروعًا وضروريًا ويأتي هذا التحول في ضوء توجه الدولة نحو توحيد المرجعية القضائية ورفع كفاءة العدالة الصحية لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق الردع والوقاية معًا فالغاية من معالجة الأخطاء الطبية قضائيًا ليست العقوبة وحدها، بل أيضًا منع تكرارها وحماية الأرواح وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
أولًا تعريف الخطأ الطبي:
الخطأ الطبي هو تصرف أو إهمال يصدر عن الممارس الصحي على نحوٍ يخالف ما جرى عليه العمل في الأوساط الطبية من أصول مهنية وعلمية، فيترتب عليه إلحاق ضرر بالمريض في بدنه أو نفسه أو حقوقه، سواء كان ذلك عن جهل أو تقصير أو سوء تقدير في التشخيص أو العلاج.
ثانيًا صور السلوك أو التصرفات المهنية التي يعدها نظام مزاولة المهن الصحية خطأ طبي يوجب المساءلة؟
يعد الخطأ الطبي – وفقًا لما قرره نظام مزاولة المهن الصحية – كل تصرف مهني يصدر عن الممارس الصحي ويترتب عليه ضرر للمريض نتيجة إخلاله بما تفرضه المهنة من عناية ومعرفة فنية.
ويدخل في ذلك صور متعددة من التقصير مثل: الإهمال في متابعة حالة المريض، أو الجهل بما يجب على الممارس الإلمام به ضمن تخصصه، أو استخدام أجهزة وأدوات طبية دون معرفة كافية بطريقة تشغيلها أو دون اتخاذ احتياطات السلامة، وكذلك إعطاء الأدوية، أو الجرعات دون تثبت، أو إجراء عمليات، وبحوث غير معتمدة.
كما يُعد من صور الخطأ التقصير في الرقابة والإشراف أو الامتناع عن استشارة المختص عند الحاجة ويبطل النظام كل اتفاق يتضمن إعفاء الممارس من مسؤوليته عن مثل هذه الأخطاء.
وبناءً على ذلك، إذا ارتكب الممارس الصحي أيًا من التصرفات أو الإهمالات السابقة فيحق للمتضرر رفع الدعوى للمطالبة بالتعويضات المستحقة على قدر الضرر، مع ضرورة توثيق الواقعة بجميع مراحلها ابتداء من التقارير الطبية حتى الضرر المؤدي للفقدان أو التقصير، وذلك لضمان حماية الحقوق وتحقيق سير العدالة.
فالغاية من هذا الإجراء ليست فقط الحصول على التعويض، بل التأكيد على التزام الممارس الصحي بالمعايير المهنية وحماية حقوق المرضى بما يحفظ كرامتهم من أي انتهاك محتمل.
ثالثًا أنواع الأخطاء الطبية بناء على المادة السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية:
1- إهمال العلاج أو نقص المتابعة:
تعريف: تقصير الممارس الصحي في تقديم الرعاية اللازمة أو متابعة نتائج الفحوصات.
مثال: ترك المريض لساعات دون متابعة أو إجراء التحاليل الضرورية.
الجانب الفقهي: إذا كان الطبيب يعلم بواجبه وتقصير، فالضمان قائم
الجانب القانوني: يندرج ضمن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، ويلزم بالتعويض عن أي ضرر.
2- الخطأ في التشخيص:
التعريف: إعطاء خاطئ يؤدي الى علاج غير مناسب أو تأخير في العلاج الصحيح.
مثال: تشخيص خاطئ يؤدي لأزمة قلبية أو التهابات حادة ما يؤدي لتدهور الحالة الصحية.
الجانب الفقهي: إذا وقع تقصير الطبيب أو جهله بما يجب معرفته فإن المسؤولية ثابتة عليه.
الجانب القانوني: يندرج ضمن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، ويلزم بالتعويض عن أي ضرر.
3- الأخطاء أثناء العمليات أو الإجراءات الجراحية
التعريف: ارتكاب خطأ فني أثناء الجراحة او استخدام الأجهزة الطبية دون معرفة كافية.
مثال: إصابة عضو أثناء العملية أو استخدام جهاز طبي بشكل خاطئ.
الجانب الفقهي: تجاوز حدود المعرفة موجب للضمان.
الجانب القانوني: يندرج ضمن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، ويلزم بالتعويض عن أي ضرر.
4- الأخطاء الدوائية
التعريف: إعطاء دواء غير مناسب لحالة المريض أو جرعة زائدة أو تداخل دوائي خاطئ.
مثال: وصف الحساسية الشديدة لمريض معروف بحساسيته دون التحقق من التحاليل السابقة.
الجانب الفقهي: وقوع المسؤولية والموجبة للضمان في حال عدم إتباع الطبيب لإجراءات التثبت والمعايير المهنية المعروفة بحسب الأصول.
الجانب القانوني: يندرج ضمن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، ويلزم بالتعويض عن أي ضرر.
5- التقصير في الاستشارة أو الرقابة
التعريف: عدم استشارة مختص عند الحاجة أو عدم إشراف كافٍ على الفريق الطبي.
مثال: طبيب مقيم يتخذ قرار حرجًا دون إشراف الطبيب المختص.
الجانب الفقهي: إذا أدى التقصير الى ضرر، فالضمان قائم.
الجانب القانوني: يندرج ضمن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، ويلزم بالتعويض عن أي ضرر.
6- التجارب الطبية أو الأبحاث غير المصرح بها
التعريف: اجراء الأبحاث أو التجارب على المرضى دون موافقة أو اعتماد رسمي من الجهات المختصة.
مثال: استخدام دواء تجربي على حالة مريض الصحية دون إذن أو موافقة مكتوبة.
الجانب الفقهي والأخلاقي: يعد التجاوز على حياة أو صحة الإنسان دون إذنه أو مراقبة الجهات المعنية يعتبر انتهاكًا للحقوق والواجبات المهنية ويمثل خرق لأخلاقيات المهنة الطبية وكرامة المريض ويجب تحميل الفاعل المسؤولية.
الجانب القانوني: يندرج ضمن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، ويلزم بالتعويض عن أي ضرر.
رابعًا الآثار والمسؤولية المترتبة على الخطأ الطبي من الناحية القانونية والمسؤولية الشرعية والأخلاقية:
المسؤولية القانونية
أ- الجانب الجزائي: إذا تسبب الخطأ الطبي في وفاة أو ضرر جسيم للمريض، يتحمل الممارس الصحي المسؤولية الجنائية.
العقوبات: قد تشمل السجن والغرامة أو كلاهما، وفق نظام مزاولة المهن الصحية.
ب- الجانب المدني: الالتزام بالتعويض المالي أو الدية عند وقوع الضرر، ويحدد مقدار التعويض وفق جسامة الضرر وطبيعة الخطأ.
ج- الجانب التأديبي: يشمل الإنذار، الغرامة، إلغاء الترخيص، أو إزالة اسم الممارس من السجلات المهنية.
المسؤولية الشرعية
أ- أي خطأ طبي يسبب ضررًا للمريض يترتب عليه الضمان الشرعي.
ب- يشمل حالات الوفاة، فقدان عضو أو منفعته، أو أي ضرر جسيم.
ج- تحقيق العدالة والإنصاف، ومحاسبة المخطئ وفق أحكام الدية أو الأرش.
الآثار الأخلاقية والاجتماعية والحق العام
أ- تأثير على المجتمع: الخطأ الطبي لا يضر الفرد فقط، بل يهز ثقة المجتمع بالنظام الصحي.
ب- البعد الأخلاقي: إخلال بالمبادئ المهنية، وتهديد لكرامة المريض وحقه في الرعاية الآمنة.
ج- البعد الوقائي: وجود مساءلة قضائية صارمة يحفز الممارسين الصحيين على الالتزام بالمعايير، ويقلل من تكرار الأخطاء، بما يحمي حق المجتمع العام في نظام صحي آمن.
وبذلك يصبح جليًا أن الخطأ الطبي لا يقتصر أثره على المريض فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله مما يجعل تدخل القضاء العام وإرساء آليات الوقاية أمرًا حتميًا ولازمًا.
خامسًا إثبات الخطأ الطبي في القضاء السعودي
إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء من أهم مراحل الدعوى، إذ تُبنى عليه النتيجة النهائية للحكم، فليس كل ضرر يعني بالضرورة وجود خطأ، بل يجب أن يُثبت المدعي أن الممارس الصحي خرج عن حدود المألوف في المهنة أو قصر في واجبه المهني، وأن هذا التقصير هو السبب المباشر في الضرر الذي لحق بالمريض.
ومن الناحية النظامية، يستند القاضي إلى عدد من المواد الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية والتي قررت أن الخطأ المهني الصحي يوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر ويستعين القضاء في ذلك بالتقارير الطبية، والمستندات، وشهادة الخبراء وبجميع وسائل الاثبات المنصوص عليها في نظام الاثبات كما يمكن للمحكمة أن تطلب رأي لجنة مختصة من الشؤون الصحية متى كان ذلك لازمًا للفصل في القضية.
أما من الناحية الفقهية، فإن قاعدة “الضرر يزال” ومن تسبب في تلف يلزمه ضمانه” تشكلان الأساس الشرعي لمساءلة الطبيب إذا ثبت أنه تسبب في الضرر نتيجة تقصير أو جهل بما يجب عليه علمه في مهنته فإذا كان الطبيب قد اجتهد ولم يتعمد الخطأ، فلا ضمان عليه وأما إن ثبت تفريطه أو جهله بأصول مهنته، فإن الضمان واجب عليه.
وتشمل عناصر الإثبات في القضايا الطبية ثلاثة أركان رئيسية:
أ- العلاقة بين المريض والممارس الصحي (من خلال المستندات أو رأي الخبراء أو التقارير الطبية).
ب- الخطأ أو التقصير ويثبت بالغالب برأي الخبراء أو تقارير الجهات المختصة.
ج- الضرر والسببية أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الطبي الخاطئ.
أوجه الدلالة على الخطأ من التقرير الطبي:
1- مخالفة الأصول الطبية الثابتة
إذا ذكر التقرير أن الطبيب خالف البروتوكول الطبي، كأن لم يجرِ فحصًا ضروريًا أو استخدم دواء غير ملائم، وهي دلالة مباشرة على وجود خطأ.
2- وجود تقصير أو إهمال واضح
تأخر في التدخل أو إهمال في المتابعة بعد العملية.
دلالة على خطأ مهني بسيط أو جسيم، بحسب الأثر.
3- الانحراف عن المعايير المهنية المتعارف عليها
إذا قرر التقرير أن الطبيب تصرف تصرفًا لا يفعله “نظيره الحريص في نفس الظروف”.
هذا هو معيار الخطأ الطبي في الفقه والقضاء.
4- وجود تناقض بين التشخيص والإجراء العلاجي
–كأن يُشخّص الطبيب مرضًا ثم يصف علاجًا أو اجراء جراحي غير متناسب معه.
قرينة على الخطأ الطبي.
الرابطة السببية بين الخطأ والضرر
حتى لو ثبت الخطأ، لا تقوم المسؤولية إلا إذا كان الضرر نتيجة مباشرة له.
كيف تُستدل الرابطة السببية من التقرير؟
1- عبارات الربط الموجودة في التقرير الطبي ذاته مثل: "الضرر ناتج عن الإجراء الطبي المذكور"، أو "الخطأ ساهم في تفاقم الحالة"دلالة مباشرة على السببية.
2- الاستبعاد أو الترجيح الطبي: إذا نص التقرير أن "الضرر قد ينشأ من عدة أسباب، إلا أن الأرجح هو الإجراء الطبي المذكور"، وهو ما يكفي للتمسك لإثبات السببية لدى المسؤولية المدنية.
3- تسلسل الأحداث الزمني والطبي: إذا وقع الضرر بعد الإجراء الطبي مباشرة، ولم يكن للمريض سبب آخر يفسره ومن الأرجح أن تكون قرينة ظرفية على السببية.
4- غياب المبررات الطبية للنتيجة: إذا كانت النتيجة غير متوقعة طبيًا لولا الخطأ، فالتقرير ذاته يكون قرينة على العلاقة السببية.
أهمية التلازم بين الخطأ والسببية:
القضاء لا يعتد بخطأ بلا ضرر ولا بضرر بلا سبب، لذا فالتقرير الطبي ورأي الخبرة والتحاليل في ملف المريض هي التي تنشأ هذا التلازم المنطقي بين السلوك الطبي والنتيجة وغالبًا يستخلص من منطوق التقرير ورأي الخبرة.
سادسًا التعويض عن الخطأ الطبي
متى ثبت الخطأ المهني والعلاقة السببية بينه وبين الضرر، انتقل النظر إلى تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر ويراعى في تقدير التعويض طبيعة الضرر ومقداره وما يترتب عليه من آثار بدنية أو نفسية أو مادية، دون النظر إلى نية الممارس الصحي ما دام الخطأ ثابتًا ويُناط بالمحكمة العامة بالرياض تحديد مقدار التعويض المستحق سواء كان دية أو أرشا أو تعويض مالي عن الأضرار المعنوية أو المادية، كما أن القضاء السعودي درج على اعتبار أن الغرض من التعويض هو إعادة التوازن بين المضرور والمتسبب ومعاقبة الفاعل، تأكيدًا لقاعدة "الضرر يزال".
ومن ثم، فإن الحكم بالتعويض لا يصدر إلا بعد استيفاء عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتقديرها بمعرفة الجهة الفنية المختصة، تحقيقًا للعدالة وحماية لحقوق المريض والممارس الصحي معًا.
الخاتمة
يتضح مما سبق أن معالجة الأخطاء الطبية لا تقف عند حد إثبات المسؤولية والتعويض عنها، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة وضع آليات وقائية تحد من وقوعها ابتداءً، وهو ما يُحقق مقصود الشريعة في حفظ النفس، ويعزز ثقة المجتمع بالنظام الصحي، فالقضاء وإن كان يعالج النتائج، إلا أن الأصل هو منع الأسباب المؤدية إلى الخطأ، من خلال رفع كفاءة الممارس الصحي، وتفعيل الرقابة، وتطوير الإجراءات النظامية والمهنية داخل المنشآت الصحية.
جود الصبحي